أركان الجريمة.
تعتبر الجريمة عموما واقعة كاملة العناصر متناسقة الأعضاء يترتب على وقوعها عدوان على المصالح الأساسية في المجتمع، و عند دراستها لابد من النظر إليها كوحدة واحدة لا كمجموعة من الأجزاء ثم تحليل جميع جزيئتها و لذلك فإن للجريمة مظهران مظهر قانوني يتحدد بالصور التي ينص عليها القانون و تسمى بالنموذج القانوني و مظهر واقعي لا يدخل في نطاق التجريم ما لم يتطابق مع المظهر القانوني للجريمة . و عليه للجريمة ثلاثة أركان عامة لا يمكن تصور قيامها بدون اجتماع كل هده الأركان الثلاثة التي هي : الركن القانوني أو الشرعي ، الركن المادي ، و الركن المعنوي .
الركن الشرعي
بادئ ذي بدء ، يقصد بمبدأ الشرعية أنه لا يجوز تجريم فعل لا ينص القانون صراحة على تجريمه كما لا يجوز توقيع على الجاني خلاف تلك الصورة المقررة قانونا . بمعنى آخر أن نص التجريم يصبح أمر ضروري لقيام الجريمة بانتفائه تنتفي هذه الأخيرة و هذا ما نصت عليه المادة الأولى من ق.ع. بأنه : " لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون ."
و لهذا تعتبر قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات من أهم الضمانات المقررة للحرية الفردية، كما أنها تعتبر ضمانة هامة للحد من التفنن بإنزال العقوبات بالمحكوم دون حسيب أو رقيب . (4)[1]
و يقوم الركن الشرعي على عنصرين هامين هما :

خضوع الفعل لنص التجريم
يجب أن يكون عنصر التجريم منحصرا في نطاق النصوص القانونية المكتوبة أي يجب أن يكون التجريم و العقاب بنص جنائي مكتوب ، غير أنه لا يكفي وجود نص يجرم الفعل و يعاقب عليه ، بل لابد أن يكون هذا النص ساري المفعول وقت ارتكاب الجريمة، و أن يطبق على مكان حدوثه و على شخص مقترفه .
فقانون العقوبات ليس أبدي فهو يتغير و يتبدل تماشيا مع متطلبات المجتمع ، و ذلك بتدخل المشرع بتعديله أو إلغائه لأن الظاهرة الإجرامية تعرف التطور .لذلك فإن ق. ع يسري تطبيقه من حيث الزمان بعد نشره في الجريدة الرسمية ، فقانون العقوبات يسري بأثر فوري و مباشر أي عدم تطبيقه على الماضي و هو ما يعرف بمبدأ "عدم رجعية قانون العقوبات " إلا أن القانون يسري بأثر رجعي أي تطبيق القانون الجديد على الماضي و تطبيقه على الوقائع قبل نفاذه و هذا هو الإستثناء .
فقاعدة عدم رجعية النص الجنائي إلى الماضي ليست مطلقة فالمشرع استثنى منها مصلحة المتهم في تطبيق النص بأثر رجعي ، فإذا كان المتهم قد ارتكب جريمة في ظل قانون قديم و جاء قانون جديد ورفع الحد الأدنى أو الأقصى للعقوبة فأي عقوبة تطبق عليه ؟.
ان القاضي الجنائي يجب عليه أن يختار من بين القوانين فإذا كان أحد القانونين يخفف العقاب على المتهم أو ينزل بدرجة الجريمة فعليه تطبيقه أي بمعنى للقاضي سلطة اختيار القانون الأصلح للمتهم ، و لكي يرجع القاضي لتطبيق هذا الإجراء لا بد من توافر شرطين :
- أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم .
- أن يكون القانون الجديد صادر قبل الحكم النهائي على المتهم .
ان القاعدة العامة تقضي أن قانون العقوبات يطبق على كامل إقليم الجمهورية بحسب ما جاء به نص المادة 12 من الدستور الجزائري " تمارس سيادة الدولة على مجالها البري ومجالها الجوي و على مياهها ..." و تنص المادة 03 من ق ع " يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ." و هذا ما يعرف بمبدأ الإقليمية أي أن قانون العقوبات يطبق على من يرتكب الجريمة بالجزائر مهما كانت جنسيته ومركزه ، إلا أن هناك أشخاص لا يطبق عليهم و هم رئيس الدولة ، رؤساء الدول الأجنبية ، السلك السياسي الأجنبي ، السلك القنصلي ، القوات المسلحة الأجنبية.
سبقت الإشارة أن المادة 03 من ق. ع تنص على تطبيق ق. ع الجزائري على جرائم ترتكب في الخارج طبقا للمواد 582« إلى 589 »
من ق. إ .ج ما يعرف عنها بالمبادئ الاحتياطبة المشارة إليها سابقا .
عدم خضوع الفعل لنص التجريم
إن توافر سبب لتبرير الإباحة يخرج هذه الأفعال من دائرة التجريم و يعيدها ثانية إلى دائرة الإباحة . على أن غالبية الفقه ترى أن أسباب الإباحة قيود ترد على نص التجريم فتعطل مفعوله و لذا فهي تنعكس على الركن الشرعي للجريمة فتعطل مفعوله إذ تخرج الواقعة من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة و قد أوردها المشرع تحت عنوان الأفعال المبررة في المادتين 39 و 40 من ق. ع. و تتلخص في كل ماأمر به القانون و أذن به القانون و الدفاع الشرعي .
و ما تجدر الإشارة إليه ، بوجود اختلاف بين أسباب الإباحة و موانع المسؤولية الجزائية ( الجنون ، صغر السن ، الإكراه المادي و المعنوي ) و هو ما سوف نوضحه في الجدول التالي
أسباب الإباحة | موانع المسؤولية الجزائية |
ذات طبيعة موضوعية تتعلق بالركن الشرعي للفعل المجرم. | تتعلق بالركن المعنوي و ذات طبيعة شخصية فقط يتمتع بها من لديه مانع المسؤولية المتمثل في فقدان الإرادة و الإدراك. |
هي أسباب موضوعية تخرج عن حدود الشخص و تتعلق بذات الفعل فترفع عنه الصفة الجرمية و تقلبه إلى عمل مشروع و مباح. و تمنع بالنتيجة العقاب عن كل من قام بالفعل أو شارك فيه. | هي تلك الأسباب التي تفقد الشخص قدرته على التمييز و الإختيار فتجعله غير أهل لتحمل المسؤولية الجنائية ، تحول فقط دون تطبيق نص التجريم ولا تمحو الفعل و لا تمنعه من ترتيب نتائج أخرى . |
تمنع من توفير تدابير من تدابير الأمن على من أعفي من العقاب | لا تمنع من توقيع تدابير الأمن على من أعفي من العقاب |
يتعدى أثرها إلى كل من ساهم في ارتكاب الجريمة فاعلا كان أم شريكا . | لا تتعدى إلى غير من يتصف بها و لا يستفيد إلا من توفرت فيه . |
تعفي من قيام المسؤولية المدنية عن الأضرار التي سببتها الجريمة . | لا تعفي من قيام المسؤولية المدنية عن الأضرار التي سببتها الجريمة. |
الركن المادي
يقصد بالركن المادي للجريمة " كل فعل أو امتناع عن فعل الذي بواسطته تكتشف الجريمة و يكتمل جسمها و لا توجد جريمة بدون ركن مادي إذ بغير مادياتها لا تصاب حقوق الأفراد أو الجماعة بأي اعتداء ". و عليه يتكون الركن المادي من عناصر تتحدد في السلوك الإجرامي ، النتيجة الجرمية ، و العلاقة السببية .
السلوك الإجرامي
من المعلوم أن المقصود بالنشاط هو السلوك الإجرامي و النشاط إما أن يكون بعمل إيجابي و قد يكون بفعل سلبي كالإمتناع . فالنشاط الإيجابي المجرم هو ذلك السلوك الخارجي الذي يتم بحركة عضوية أو عضلية نهى القانون عن القيام بها ، و هذه الحركة العضوية أو العضلية يجب أن تكون إرادية أي أن الشخص حين قيامه بالفعل كان له السيطرة التامة على كامل أعضائه كاستعمال أصبعه في الضغط على زناد البندقية أو استعمال يده في أخذ مال الغير في جريمة السرقة و بالتالي يستبعد كل حركة غير إرادية كمن يصاب بإغماء و يسقط على طفل و يصيبه ففي هذه الحالة لا يعتبر الشخص مرتكبا لجريمة لأنه لم تكن له إرادة حرة وواعية في توجيه سلوكه . أما السلوك الإجرامي السلبي فعرف على أنه إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي متى كان هناك واجب قانوني و من صور الإمتناع السلبي الإمتناع عن تسديد النفقة المنصوص و المعاقب عليه في المادة 331 من ق.ع و امتناع القاضي عن الفصل في القضايا المعروضة عليه طبقا لنص المادة 136 من ق ع و امتناع الشاهد عن الإدلاء بالشهادة أمام الجهة القضائية المختصة طبقا لنص المادة 97 من ق. إ ج
النتيجة الجرمية
و يقصد بها ذلك التغيير الذي يحدثه النشاط الإجرامي على نحو لم يكن موجودا قبل ممارسة الفعل المجرم ، و هذا هو المعنى المادي للنتيجة الجرمية ، و تبعا للمدلول المادي للنتيجة تنقسم الجرائم إلى جرائم مادية و جرائم شكلية ، أما فيما يخص الجرائم المادية فهي الجرائم التي يستلزم القانون في أكثر الجرائم أن ترتب نتيجة إجرامية معينة ناشئة عن سلوك المجرم كالقتل و هو إزهاق روح إنسان على قيد الحياة الذي لا يتصور وقوعه إلا إذا حصلت الوفاة كنتيجة له و هي نتيجة ضارة . أما الجرائم الشكلية فلا يعتد فيها حصول نتيجة إجرامية بحيث أن المشرع الجنائي يجرم و يعاقب عليها و إن لم ينجم عنها أي نتيجة إجرامية كحمل السلاح بدون رخصة و جريمة الإمتناع عن إبلاغ السلطات بجريمة تخل بالأمن العام و جريمة الإمتناع عن الشهادة. أما المعنى القانوني فيعني الإعتداء على حق يحميه القانون و يحيطه بالرعاية الجزائية ، وعليه تنقسم إلى جرائم ضرر حيث يشترط القانون للمعاقبة عليها حصول نتيجة جرمية معينة أو احتمال حصولها كالمحاولة وإلى جرائم خطر فهي سلوكات إجرامية لا يشترط القانون في تجريمه إياها وقوع نتيجة إجرامية ملموسة ما يكثر تطبيقها في مجال الجرائم الاقتصادية[2][2] لما لها من تأثير سلبي على المصلحة الاقتصادية العامة ، وعلى هذا الأساس فإن المشرع كثيرا ما يتدخل ابتغاء الوقاية ليضفي الوصف الجرمي على أفعال تتم عن خطورة . (5)[3]

العلاقة السببية
يشترط لقيام الركن المادي في أي جريمة أن يكون الفعل أو الإمتناع الذي ارتكبه الجاني هو سبب وقوع النتيجة الجرمية و هو ما يطلق عليه علاقة أو رابطة سببية . فإذا انقطعت علاقة سببية بين الفعل والنتيجة الجرمية أو كانت منفصلة 1عنها فإنه لا يمكن القول بقيام مسؤولية مرتكب الفعل لانعدام علاقة سببية بين الفعل و النتيجة.
الركن المعنوي
لا يكفي قيام المسؤولية الجزائية أن يصدر عن الفاعل سلوك إجرامي معاقب عليه أي ارتكاب فعلا من الأفعال التي يعاقب عليها ق. ع ، فلابد لقيام المسؤولية الجزائية لهذا الجاني توافر الركن المعنوي ينم عن اتجاه إرادته إلى ارتكاب سلوك إجرامي مع علمه بــأن هذا الفعل يعاقب عليه القانون .و عليه تنقسم الجرائم بناءا على الركن المعنوي إلى :
جرائم عمدية
و التي يشترط فيها القانون توافر القصد الجنائي على أنه انصراف الإرادة إلى السلوك المكون للجريمة كما وصفه نموذجها في القانون ، مع وعي ( العلم) بالملابسات التي يتطلب هذا النموذج إحاطتها بالسلوك في سبيل أن تتكون به الجريمة ، كما يعرف على أنه " العلم بعناصر الجريمة و إرادة إرتكابها " و عن المشرع الجزائري فإنه لم يعرف القصد الجنائي ، بل اكتفى على عبارة " العمد " للدلالة على وجود القصد الجنائي لقيام المسؤولية الجزائية مثل ما ورد في نص المادة 254 من ق .ع " القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا " ، و في نص المادة 264 منه كذلك " كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه " ... و من التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص العناصر التي يقوم القصد الجنائي و هما العلم و الإرادة. (6)[4][4] [4]
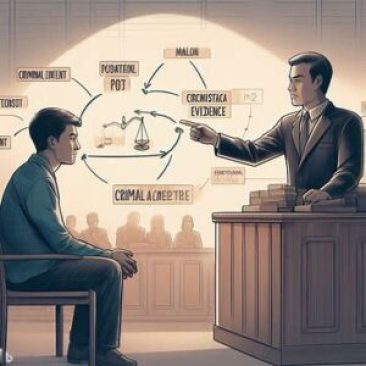
جرائم غير عمدية
و هي التي يتحقق ركنها المعنوي نتيجة خطأ غير عمدي بتوافر فقط بسلوك خاطئ يأتيه الفاعل عن إرادة و لكن دون استهداف للنتيجة التي قد تترتب عن هذا السلوك ، و الذي تتجلى صوره في الإهمال ، الرعونة ، عدم الإحتياط ، عدم مراعاة الأنظمة القانونية و اللوائح . وهذا حسب ما نصت عليه المادة 288 من ق. ع .